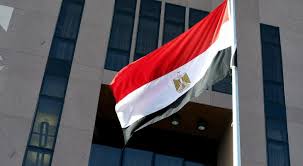سوريا بعد سقوط الأسد: تحديات الانتقال وإعادة بناء الدولة

في لحظة فارقة من التاريخ السوري، لا تعود مسألة بقاء بشار الأسد أو رحيله مجرد نقاش سياسي، بل تصبح اختبارًا حاسمًا لجوهر الدولة السورية. فالأسد لم يكن فقط حاكمًا، بل ركيزة لبنية استبدادية استوطنت مفاصل السلطة والمجتمع والدولة. ومع ذلك، فإن اختزال الأزمة السورية في شخصه يبقى تبسيطًا مخلًّا لحقيقة أعقد. فالسؤال الحقيقي اليوم لا يتعلق بمن يحكم، بل: ماذا تبقّى لنُحكم عليه؟ هل ما زالت هناك دولة يمكن إنقاذها، أم أننا نقف على أطلال وطنٍ تفتتت جغرافيته، وتحطّمت ثقته، وذابت هويته بين الحروب والنزوح والخذلان؟
الحديث عن “سوريا ما بعد الأسد” لا يعني بالضرورة ولادة جديدة، بقدر ما يطرح إمكانية نادرة لإنهاء مرحلة مأساوية وإعادة بناء وطن فقد تماسكه. ذلك أن سقوط رأس النظام لا يضمن سقوط بنيته. فقد أثبت النظام قدرته على التكيّف مع أزماته، سواء عبر التمترس خلف الحلفاء الدوليين، أو بإعادة إنتاج أدوات القمع والسيطرة، أو حتى عبر خطاب مقاومة زائف جعل من بقاء الأسد مرادفًا لوحدة سوريا. لكن الواقع يُكذّب كل ذلك؛ فالبلاد عمليًا مقسّمة، ليس فقط من حيث السيطرة العسكرية، بل من حيث الرؤى والمصالح والهويات أيضًا.
في الشرق، ثمة كيان كردي شبه مستقل يسعى إلى اعتراف دولي غير مضمون، تديره قوى كردية بدعم أمريكي حذر. في الشمال، مناطق تحت سيطرة فصائل تديرها أنقرة ضمن استراتيجية أمن قومي عابر للحدود. في الجنوب، خلايا تتبع مصالح محلية تتغير بتغير المزاج الدولي. وفي الوسط والساحل، ما تبقى من دولة تُحكم شكليًا من دمشق، لكن القرار فيها موزع بين موسكو وطهران. وسط هذا المشهد، يصبح الحديث عن “وحدة سوريا” أقرب إلى شعار مفرغ من المضمون ما لم يُطرح ضمن مشروع وطني شامل يتجاوز المركزية، ويعترف بالتنوع، ويعيد تعريف معنى الدولة.
لكن مع سقوط الأسد، يبقى السؤال الأهم: من يملأ الفراغ؟ فالمعارضة التقليدية تبدو منقسمة ومثقَلة بتاريخ من الإخفاقات والارتهانات الخارجية، والحركات المسلحة التي تصدّرت المشهد العسكري فقدت الكثير من مشروعيتها في نظر الداخل والخارج. أما القوى المدنية، ورغم ما تمتلكه من حيوية، فلا تزال تفتقر إلى الفضاء السياسي الآمن والمستقل الذي يمكنها من العمل بحرية. لا أحد يمتلك التفويض الشعبي الكامل ولا رؤية انتقالية متكاملة. من هنا، تبدو الحاجة ملحة لمرحلة انتقالية تُبنى على توافق دولي وإقليمي، لكنها أيضًا تحتاج إلى شرعية نابعة من الداخل السوري، من مجتمع أنهكته الحرب لكنه ما زال يملك القدرة على الحلم والتغيير.
وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل التحولات الإقليمية والدولية التي أسهمت في لحظة التغيير. إذ تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة قد فتحت المجال أمام تركيا للعب دور ريادي في مستقبل سوريا، ضمن تفاهمات مع روسيا، التي وافقت – ضمنيًا – على تقليص وجودها العسكري مقابل تقليص الدعم الأميركي لأوكرانيا، والضغط على إيران وأذرعها في سوريا ولبنان، وفي مستوى أقل العراق. كما كُلّفت السعودية، وفق هذه الصفقة، بلعب دور قيادي في ملف إعادة الإعمار، من خلال تمويل ومشاركة مباشرة، مع إشراك دول عربية أخرى في هذه العملية، مثل الإمارات وقطر والعراق. بهذا، يظهر أن العامل الدولي لا يزال حاضرًا بقوة، عبر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فيما تلعب تركيا دور الفاعل الإقليمي الأبرز، إلى جانب إسهامات سعودية وخليجية مرتقبة في عملية إعادة البناء.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى ملف إعادة الإعمار أحد أكثر القضايا تعقيدًا، لا فقط لأنه يتطلب مئات المليارات، بل لأنه يرتبط بسؤال أعمق: هل تُبنى سوريا على الأسس القديمة نفسها؟ وهل يُمكن السماح بإعمارٍ تحت سلطة لا تعترف بالمساءلة؟ التجربة تقول إن الإعمار في غياب العدالة ليس إلا عملية تغليف للأنقاض. لا يمكن تصور عودة الحياة إلى سوريا دون بناء مؤسسات شرعية وشفافة، تعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُخرج الاقتصاد من يد أمراء الحرب وشبكات الفساد.
العدالة الانتقالية في هذا السياق ليست خيارًا، بل شرطٌ للشفاء الوطني. سوريا لا تحتاج فقط إلى بناء الحجارة، بل إلى ترميم ذاكرة شعب. إلى اعتراف بالضحايا، إلى مساحة للحقيقة، حتى وإن كانت موجعة. فالمجتمعات التي تُقصي آلامها إلى الخلف، تعيد إنتاجها في المستقبل بشكل أكثر شراسة. العدالة ليست بالضرورة عقابًا، لكنها لا يمكن أن تكون نسيانًا.
رغم كل ذلك، ما زال هناك ما يُراهن عليه. فالسوريون، داخل البلاد وخارجها، لم يتوقفوا عن محاولة صياغة معنى جديد لوطنهم، سواء عبر الفن، أو الثقافة، أو التعليم، أو التوثيق، أو حتى في أبسط محاولات الحياة اليومية في المخيمات والمنافي. هذه المحاولات، المتناثرة والمتواضعة، تحمل في داخلها بذور التجديد. ليس لأنهم أقوى من الجغرافيا السياسية، بل لأنهم وحدهم يملكون القدرة على إعادة تعريف “الوطن” خارج قوالب السلطة والمعارضة.
إن سوريا القادمة لن تُبنى بشعارات المنتصرين، ولا بتفاهمات القوى الكبرى وحدها، بل بإرادة السوريين في صياغة عقد جديد، يتسع للجميع، وينهي الحقبة التي اختُزلت فيها الدولة بشخص، والوطن بحزب، والكرامة بشعارات. لذلك فإن ما بعد الأسد، إن أُريد له أن يكون بداية لا فراغًا، يجب أن يكون لحظة تأسيس فعلية لدولة حديثة، تنتمي لمواطنيها لا لماضيها.
هل يمكن ذلك؟
نعم، إذا أُعيد الاعتبار لفكرة الوطن كفضاء للعدالة والمشاركة، لا كغنيمة لمن يملك السلاح أو يكتب الدستور نيابة عن الشعب. سوريا لا تحتاج فقط إلى نهاية مرحلة، بل إلى بداية صادقة، تبدأ من القاع، من الألم، من الحقيقة. لا من الصور الكبيرة في الساحات، ولا من التصريحات في المؤتمرات. إنها بحاجة إلى وطن، لا إلى سلطة أخرى.