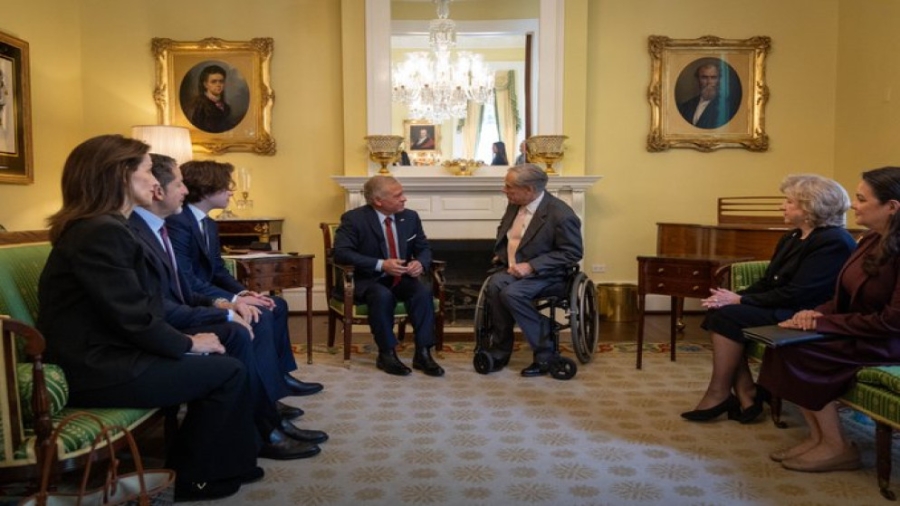ساعتي ذكية ولا أريدها

كنت بعدُ في العاشرة حين قيّدت معصمي بساعة "كاسيو" الرقمية، ومن لحظتها، صرت صبي الـ"كاسيو"، وما غفلت عيني عن تلك الأرقام التي تتقلّب كأنها هي من يدخلني عصر التكنولوجيا. منحتني تلك الساعة شعوراً بالإثارة، فصرت أسابقها فأعدّ الثواني مغمض العينين... 20 ثانية، ثم 40 ثانية، ثم 60، فأفتحهما كي أتأكد أنني مواكب إيقاع زمن الـ"كاسيو". وبعدها، سادت موضة الساعة - الآلة الحاسبة، بأزرارها المنمنمة الصغيرة، التي كان عليّ أن أسلمها لاستاذ الرياضيات قبل الامتحان. رافقتني الساعة الرقمية ردحاً من الزمان، حتى نسيت تسميات الوقت، فما عادت الساعة العاشرة إلا ربعاً، بل صارت 9 و45 دقيقة، وما زالت.
بعد مضي أقل قليلاً من نصف قرن، ما زالت ساعتي تقيّد معصمي، بل ساء أمري أكثر، إذ صرت مكبلاً بساعتي الذكية السوداء، بحزامها المطاطي وشاشتها الداكنة. كانت الساعة الحلم، أو هكذا ظننت، فهي تتتبّع حركتي، فتضيء إن تحركت، وتسجل علي خطواتي، وتدفعني دفعاً إلى إتمام 10 آلاف خطوة في اليوم، كما تعدّ سعراتي الحرارية، وتفشي أسراري القلبية والعصبية والنفسية، وتحصي علي أنفاسي، وتراقب تشبّع الأكسجين في دمي، وترشدني إلى هاتفي الذكي إن ضلّ طريقه... وأنا راضخ لمشيئتها، أركض لشحنها حين تطلب الطاقة، تماماً كما أركض لتأمين قوت عائلتي. وفي كل عام، أهبّ لشراء الإصدار الجديد رغم أنني عارف تمام المعرفة أنها لا تتميز من الإصدار القديم، إلا في مسألة أو اثنتين من المسائل التي لا أستخدمها في العادة.
أستيقظ صباحاً، فتبشّرني ساعتي الذكية بأن جودة نومي كانت منخفضة: "لم تنم جيداً في الليلة الماضية، ولم يتعاف جسدك، ومرجّح أن تشعر بالتعب اليوم". كانت محقة، فقد شعرت بالتعب في ذلك اليوم. لكن، للآن لم أعرف ممّ تعبت، أهو إرهاق حقيقي أم هو وهم زرعته ساعتي هذه في اللاوعي؟ وحين أخبرت زوجتي أن ليلتي كانت صعبة، سألتني باستغراب: "ومن أخبرك بهذا، فقد نمتَ نوم القتيل؟"... "ساعتي". رمقتني بنظرةٍ لسان حالها: "هل استعبدتك ساعتك وقد ولدتك أمك حراً؟".
صار تفقدي ساعتي هذه - بإشعار وبدون إشعار - غريزياً، وكأن فيها يجتمع عالميي الافتراضي والواقعي. تشعرني أحياناً بأنني أعيش أحلام اليقظة بشكل لم يعد يبتعد كثيراً من الهلوسة، أو الإدمان إن أردنا تجنب المبالغة. إن دهاة التقانة قادرون، بفكرة واحدة، توجيه دفة إدماننا الرقمي، حتى صرنا راضين مسلّمين بقضاء يرسمونه لنا، تحت شعار العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي. إنهم يبيعوننا الساعات الذكية وكأنها ترياق لإدمان الهواتف الذكية. لكن أن تدمن الساعة لتحدّ من إدمانك الهاتف أمر يفتقر إلى الذكاء، تماماً مثل الإفراط في تناول الحلويات، كي تشفي إدمانك على الحلويات.
ربما علينا التمهل قليلاً، والعودة إلى بساطة الروحانيات اليومية، وإهمال التنبؤات الذكية الاصطناعية. ربما علي البحث في صناديقي عن ساعتي الـ"كاسيو" القديمة، والرجوع إلى عهد الساعة عداد الثواني والعمر، ليس إلا. فإن إيماننا بقدرة التكنولوجيا على تغيير مسار حياتنا صلب جداً، إلى درجة فشلنا في إدراك الحقيقة.